الإشارةُ حين تكونُ دليلاً حفرٌ في مثاباتِ عرضِ مسرحيةِ (الإشارة)/ جبّار ونّاس
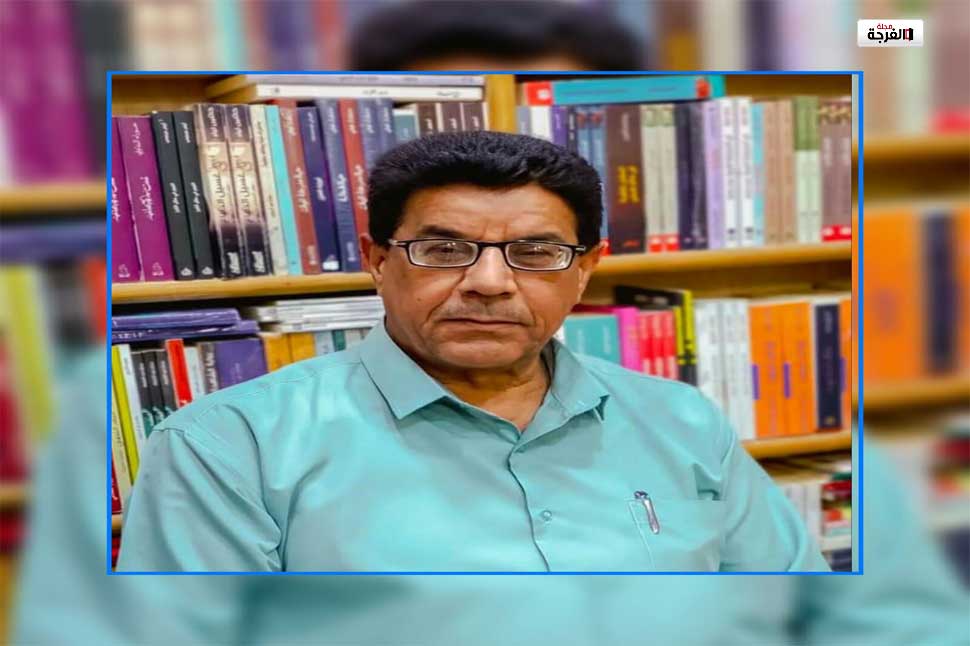
ماذا نتوخى من الفن حين يترافدُ أمامنا ومن حولنا ناطقاً، متبصراً، مرشداً، صارخاً بكل ما يعتملُ في دواخلنا لِأنْ تتحركَ، تنطقَ هي الأخرى، تتسامى بمقدار ما يقابلها من فيوضات الفن؟
هذا سؤالٌ سيجعلنا نعيدُ التأملَ بممكناتِ عمليةِ التوخي تلك والتبصرِ الدقيقِ بتفاصيل ما تأتي به هذه الممكناتُ لتكونَ حاسمةً ودقيقةً هي الأخرى حين ترى الفن وقد أخذَ من مراتبِ الواقعِ ما يستحق الثناء في الفعل والحضور ذلك أنَّ الفنَّ وُجِدَ كيما يكونَ عيناً مبصرةً تُضاف إلى عيون الناس في واقعِ حياتِهم بل وتقودُهم إلى سرائر ما تتبطن به دواخلُ واقعهم.
وفن المسرح بوصفه تحشيداً جماعيا ينتمي إلى دائرة العلن والإشهار ومن سرائره المائزة على الدوام هي قدرةُ البوحِ صوتاً وصمتاً وبحكم ما تتظافر به حواضنه من مشتركات فاعلة كلها تهمس، تتحرك، تنطق، تصول، تُعلن، تهجسُ بما هو ظاهر وما هو مُضَمَرٌ فهي مشتركاتٌ تبدأ بالكلمة، بالجسد، بالضوء بالموسيقى باللون، بالمكان، بالزمن.
– متن النص :
لم تسلك الكاتبة أطياف رشيد في بناء نصها ( الإشارة) وفق الأسلوب التقليدي بل ذهبتْ بإتجاه إسلوب يحتدم بالسؤال وقد جعلت من فعل الحدث ليكون من الذروة بعد حدوث التفجير وتصاعد الأغبرة والدخان وتهشم الأبنية فكان النص محتشدا بفعالية السؤال الذي تواجد بين تفاصيل الحوار لثلاث وثلاثين مرَّةً يُضاف إلى أنَّ الكاتبة إعتمدتْ في تشييد نصها على شخصيتين نمطيتين تمثلت بالشخص الأول والشخص الثاني وفي هذا تريد أن تعطي بعدا يتجاوز التحديد إلى التعميم وأيضا في إيجاد الشخصية الثالثة المتمثلة بالطفلة وهي شخصية تمارس في فعلها الحضور والغياب وأيضا في الشخصية الرابعة وهي خارجية تمثلت بحضور صوت رجل العسكر الذي يسمح للناس بالمرور بعد إنتهاء الإجراءت والإحترازات الامنية التي ترتبت من جراء التفجير..
والنص رغم قصره بيد أنّْه عمل على التشبث بفعل ودور الذاكرة لأنْ تكون راكزة متوثبةً على الدوام إذ إنَّ الحدثَ الذي حصل لايمكن التوقفُ عنده بسهولة ومن ثم تجاوزه إذا ما علمنا أنَّ ثمة إستهدافاً كبيراً ومروعا قد نال بآثاره الجسد والمكان واحلام الناس فكانت لأزمة الإسترجاع التي عملت عليها الكاتبة أطياف ناجعةً كوسيلة إسلوبية تتبناها وهي تطرح لنا كقراء ومشاهدين تفاصيل نصها..
متن العرض:
لم يكن المخرج ( محمد زكي) بعيدا عن المثابات التي وجدناها في نص الكاتبة ( أطياف رشيد) غير أنَّه صار يعمل على إجتراح لطريقة عرض تمثلت بإضافات نصية ومشهدية مرئية تكاد تقترب وتلامس عن قرب اسماع وعيون الجمهور الذي حضر لمشاهدة العرض..
فالمخرج عمل هو الآخر ما بعد التفجير الذي حصل ومضى وبقيت آثاره ماثلةً على جسد وسلوك وتصرفات الشخصيتين الأول والثاني فكان فعل الإخراج قد مال الى السكون والإنحسار والعزل المقصود والذي حمل معه إشارة نحو الملل بعدم الجدوى في التبصر فيما حصل وهذا نجده مع المشهد الثاني وعملية التنظيف وإزالة وكنس ما تبقى من بقايا مادية للتفجير فصرنا نشاهد أحد المنظفين وفي حركة تقول لنا أن لاجدوى في شيء إحترق وراح بمكنسة التنظيف وكأنّه يركل أو يدفع بصورة غير مالية..
وبما أنَّ نص الكاتبة أطياف رشيد قد إعتمد على طريقة الإسترجاع لجعل الذاكرة في توقد وبمصاحبة لسير ما حدث وما يحدث فإنَّ المخرج ( محمد زكي) قد تبنى هو الآخر تلك الطريقة حين أعاد أمامنا فعل التفجير الذي حصل وقد سبقه حوار بين الشخصيتين ليكون التفجير وإحتراق سيارة الإسعاف خلاصة لما ورد من سرد على لسان الشخصيتين اللتين تعانيان من العزلة والمحاصرة وأيضا حصلت لنا طريقة الإسترجاع وإستهداف الذاكرة حين بدأ المشهد الإستدلالي بمسمع إذاعي بصوت الشاعر ميثم راضي وقد قدم لنا مسحا ميدانيا لمثابات الحزن والألم الذي توزع ما بين التهجير والنزوح وموت الأم أو موت الأب وأعمال الإرهاب وقتل الطفولة والبراءة والتي جعل منها الشاعر وكأنَّها المعادل الموضوعي الذي يساوي الله…
وفي التبصر لما جاءت به طريقة العرض التي شيدها أمامنا محمد زكي يمكن أن نجد الآتي :
– نرى أن المخرج يميل إلى فكرة التعميم ولم يقترب الى التحديد المجرد بعينه
– وجدنا أنَّ المخرج يميل إلى إستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تستعير لها من تقنية السينما كالشاشة الخلفية وكذلك في إستخدام مساقط ضوئية عبر تقنية الداتاشو حين يمكن التصور بسهولة نقل هذا العمل إلى أماكن عديدة..
– ثمة إشتغال فني نجح المخرج في تقديمه حين إستطاع أن يجعل من موجودات العرض المتمثلة بسيارة الإسعاف المحترقة والمهشمة وقناني الأوكسجين وشاشة التلفزيون لأن تكون هذه الموجودات البصرية فاعلة وتأخذ لها مساحة من الفعل والتأثير العاطفي والإنساني وبالذات مع مفردة قنينة الأوكسجين التي صارت تتجسر وتبدو أكثر حضورا من فعل ووجود المفردة المركزية للعرض وهي سيارة الإسعاف فلقد أتقن المخرج الوظيفة التي تعددت بها قنينة الأوكسجين فمرة نراها تمتلىء بالقيح والتلوث والجراح وفي المرة الثانية يتم التعامل معها كأجساد تعاني من الإحتراق ومحاولة إعادة الحياة لها وفي مرة أخرى نراها تصبح أداة لقراءة زمن الحدث ومراحل تدرجه في الإنخفاض والتلاشي عند نهاية العرض
– يبدو فعل خروج الأوكسجين وإرتفاع صوته ليدلل على إستمرار وإمكانية أن ينتقل الإحتراق والنيران إلى أماكن أخرى فهذا الصوت المتكرر لخروج الأوكسجين ما هو ألا إشارة إلى حالة الإحتراق الكبير الذي يمكن أن يشمل بآثاره على أجساد ومدن وفي مدى أوسع ليشمل وطنا والذي هو العراق وهذا ما أشار له العرض حين مال ومن خلال الحوار بين الشخصيتين إلى اللعب مابين الحلم والواقع والكابوس ليقول عن واقع مأساوي عاشه ومايزال يشهده العراق
– نرى العرض يميل إلى السخرية وقد تمثلت باشعار وصوت ميثم راضي حين يتحدث عن الوطن والنشيد الوطني وتلك هي من الصور التي تعد ناجعة حين يتم الحديث والتطرق إلى حالة الفنتازيا التي يشهدها واقع غريب كالواقع في العراق.
وميثم راضي صار يدبجُ من مفازات الخراب التي حلت بهذا البلد وناسه لِيُعيدها إلينا بترشيحات ما تمحصه المخيلة فيبدو مدهشا اثيرا وهنا مكمن الإشتغال الفني الذي سيكون واخزاً منبهاً وفي نفس الوقت ماتعا بثراء روح البوح حين يَتَعَمَدُ بغنائية الشعر فبهذه الغنائية يسحب من العواطف والشجن الكثير
ـ ولعل من المناطق المهمة في عرض الإشارة تقف منظومة الإضاءة وفعل الألوان في تداخلها وبروزها المتميز مع اللون الاحمر
– تبدو منظومة الأداء من المفاصل التي ترشحت أمامنا وبرغم حالة العزلة وحصر الممثلين في مساحة إلا أننا قد شعرنا بحالة الإنهيار والضعف والإحتراق الجسدي والنفسي الذي وصل إلينا بأداء الممثلين ( أصيل عساف وجمال عساف) وقد إتضح أداؤهما بعد خروجهما من بطن السيارة والجلوس أمامها بملابس تميل إلى اللون الرمادي
وحسنا فعل المخرج حين لم يظهر الممثل ( محمد حمزه) بجسده ليكون ممثلا للشخصية الثالثة وهي شخصية الطفلة وقد عوض عنها المخرج بفعل فني وبإشتغال معبر عن الأمل حين راح احد الممثلين وبحركة يحاول من خلالها إعادة الحياة للهيكل المسجى بجانب السيارة المدمرة من جراء التفجير….
وكان لابد من التذكير بجهود مصمم السينوغرافيا ( على زهير المطيري) وكذلك بالتقنيات الرقمية ل ( على عادل) وإدارة المسرح من قبل الفنان ( كمال عساف) والتصوير السينمائي للفنان ( حسين العكيلي)…
